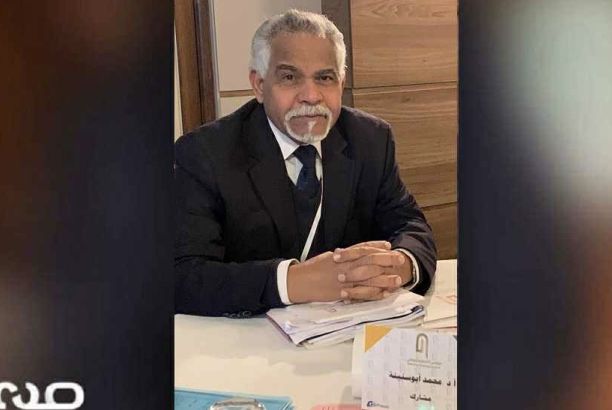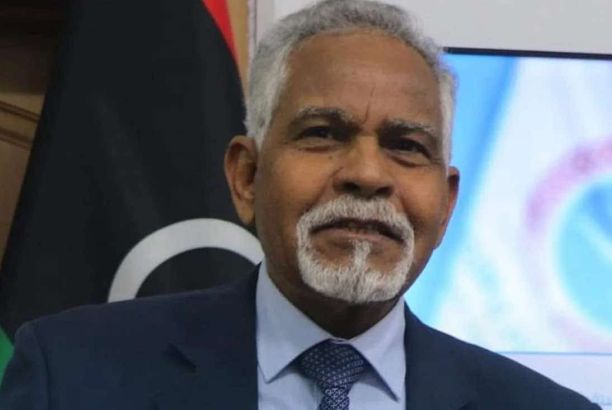الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” يكتب مقالاً، قال خلاله:
يُلاحظ من خلال ما يتم تداوله ومناقشته في الأوساط التشريعية والتنفيذية، ولدى بعض المؤسسات السيادية الرقابية، حالياً وطوال العقد الماضي، ميلٌ كبير لتعديل بعض القوانين (الأساسية)، وفي بعض الأحيان التوجّه لإصدار قوانين جديدة. ومن بين القوانين التي طالها التعديل: القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، المعدّل بالقانون رقم (46) لسنة 2013، والقانون رقم (3) لسنة 2007م بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية بموجب القانون رقم (19) لسنة 2013، والقانون المنظّم لهيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013، والتعديلات التي أُجريت عليه بموجب القانون رقم (2) لسنة 2023. وما صاحب هذه التعديلات في القوانين المنظمة لعمل الأجهزة الرقابية من تداخل وتنازع في الاختصاصات أثّر سلباً على جهود هذه الأجهزة في إحكام الرقابة على المال العام.
واليوم، يُصدر مجلس النواب قانوناً ينظّم الدين العام، لأغراض تمرير ميزانية عامة للدولة، تصدر خلال الربع الأخير من السنة المالية، في ظل وجود القانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن الدين العام، الذي نجح في السابق في كبح جماح الحكومة في ترتيب المزيد من الدين العام، واستقرت معه الأوضاع المالية في البلاد. يصدر هذا القانون الجديد على النحو الذي يطلق يد الحكومة في التمويل والإنفاق فوق ما هو متاح من موارد لتمويل الإنفاق العام، عن طريق الاستدانة وترتيب المزيد من الدين العام، مما يهدد الاستدامة المالية للدولة. وكان بالإمكان عدم المساس بالقانون رقم (15) لسنة 1986 كقانون عام، والاكتفاء بالنص في قانون الميزانية بجواز الاقتراض لتمويل العجز في حدود سقف محدد ولأغراض غير استهلاكية مسبقاً، باعتبار قانون الميزانية قانوناً خاصاً.
يصدر هذا التعديل القانوني الجديد في ظل الانقسام، ووجود حكومتين، وفي فترة تتصف بعدم كفاءة الإنفاق العام، مع وجود دين عام في دفاتر المصرف المركزي في ذمة الحكومات المتعاقبة لم يتم الانتهاء من مراجعته وتدقيقه، إضافةً إلى المخاطر التي تهدد استقرار سعر صرف الدينار الليبي.
وخلال السنوات السابقة، تم اللجوء إلى تعديل بعض القوانين بقرارات أو مراسيم؛ فقد “تم تعديل العديد من القوانين بموجب قرارات صادرة عن جهات مختلفة، بما في ذلك مجلس النواب ومجلس الوزراء. ومن بين هذه التعديلات: قانون نظام القضاء، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العقوبات، وقانون الجنسية، وقانون المطبوعات، وقانون النشاط التجاري. كما تم تعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب.”
ويتغاضى المنادون بتعديل القوانين السارية أو استحداث قوانين جديدة، عن أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية وتعاني من انقسام مؤسساتي، وأن الأوضاع غير مستقرة بصفة عامة، وأن خلخلة المنظومة التشريعية القائمة قد يزيد الأمور تعقيداً، أو يرتّب مستجدات تؤدي إلى تعميق حالة الانقسام. فضلاً عن أن التعديلات المتكررة للقوانين لا تشجّع دخول الاستثمارات الأجنبية، وتحدّ من إمكانات التعاقد بأسعار منخفضة، وتفضي إلى تصنيف متدنٍ للدولة، بسبب ما يراه المستثمر أو وكالات التقييم الدولية من عدم يقين ومخاوف؛ ذلك لأن الخلل قد لا يكون في التشريعات والقوانين السارية، بقدر ما هو في البيئة التي تعمل فيها هذه القوانين، والحالة السياسية التي تحول دون تحقيق هذه القوانين لأهدافها.
وقد يتضح للمشرّع، بعد استقرار الأوضاع وتولّي إدارة البلاد حكومة واحدة، أن ما تم استحداثه من قوانين أو ما جرى عليها من تعديلات لا يتوافق مع متطلبات واستحقاقات المرحلة الجديدة عندما تستقر الأمور، مما سيدعو إلى جولة جديدة من الإجراءات القانونية التي ستنصبّ حول تصويب آثار القوانين المستحدثة أو القوانين التي أُدخلت عليها تعديلات إبّان المرحلة الانتقالية. وقد تجد السلطات الجديدة، أي بعد استقرار الأوضاع وتوحيد البلاد، صعوبة في التعامل مع الآثار المترتبة على القوانين المستحدثة، والحقوق التي اكتُسبت في ظلها.
وباستثناء ما تتطلبه المرحلة الحالية من تشريعات تجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتهريب والاتجار بالبشر، ومكافحة الفساد، فإن البلاد ليست في حاجة لإصدار تشريعات جديدة، بقدر حاجتها إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات السارية.
ولذلك يُنصح دائماً، أثناء فترات النزاع، أن تُدار الأمور وفقاً لأساليب ومبادئ إدارة الأزمات، والتي من أهمها تفادي المساس بالبنية القانونية للدولة، خصوصاً في غياب دستور دائم ينظّم الحياة والعلاقة بين السلطات بشكل واضح. فاستقرار البيئة التشريعية يعتبر مطلباً ضرورياً لاستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية