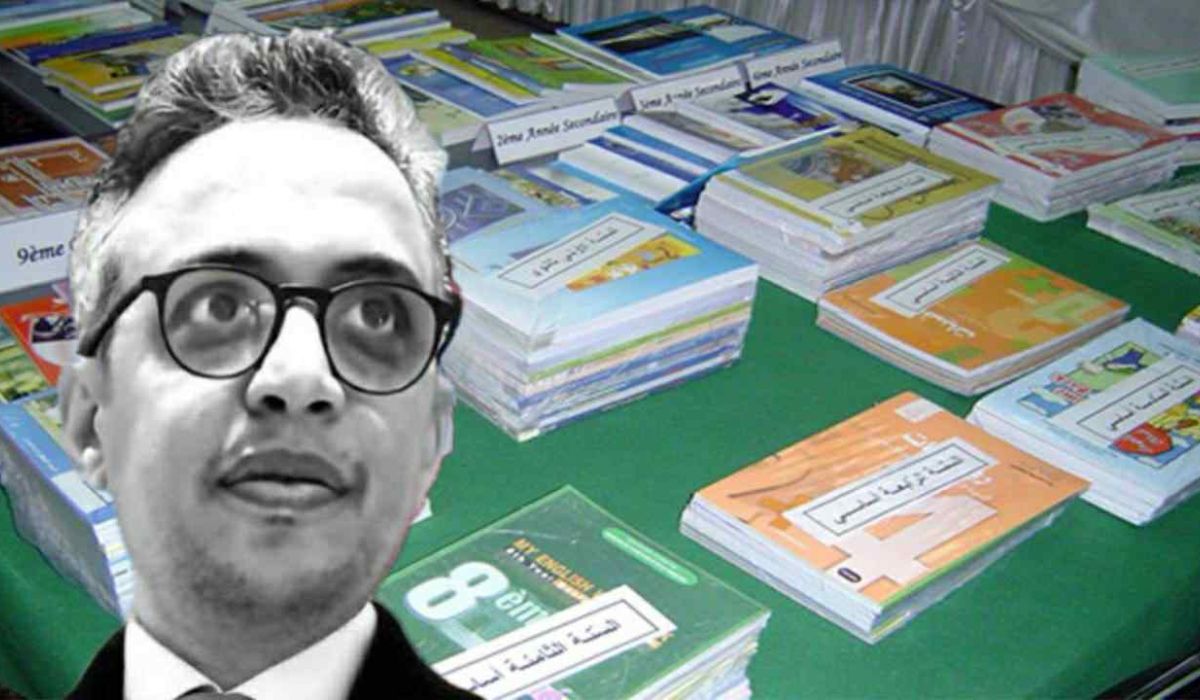كتب “أحمد زاهر” مقالًا قال خلاله:
لم يكن قرار طباعة الكتاب المدرسي داخل ليبيا إجراءً تقنيًا فحسب، بل خطوةً استراتيجية هدفت إلى بناء صناعة سيادية ترفد الاقتصاد الوطني، وتوفّر فرص عمل فنية، وتُعزّز ثقافة الإنتاج والمعرفة.
في بداياتها، نجحت سياسة توطين الطباعة في خلق قطاعٍ حيوي تطوّر تدريجيًا، فاستثمرت المطابع في المعدات والكوادر، وتمكنت بعضُها من تنفيذ كامل عقودها داخل منشآتها بجودةٍ عالية.
كانت تلك تجربة واعدة أثبتت أن الدولة حين تضع رؤيةً صناعية متماسكة يمكنها أن تحوّل الكتاب من منتجٍ إداري إلى رافعةٍ اقتصادية وثقافية.
لكن السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة شهدت انحرافًا واضحًا عن هذا المسار، تغيّرت السياسات، وفي غياب رؤيةٍ تنموية، أُسنِدت العقود إلى شركاتٍ أجنبية، بعضها لا يمتلك وجودًا فعليًا في بلده الأصلي أو يفتقر إلى القدرة التشغيلية، فاستُخدمت واجهاتٌ لتنفيذ الطباعة عبر مطابع أخرى من الباطن، مقابل عمولاتٍ رفعت من كلفة الإنتاج بدل أن تُخفضها.
هكذا تحوّل القرار الذي وُضع لبناء الاقتصاد إلى أداةٍ لتفكيكه، إذ جرى اختزال الكلفة في بندٍ محاسبي ضيّق، وتجاهلت الدولة أن الاستثمار في الطباعة ليس إنفاقًا بل قيمةٌ مضافة تنتج دورةً اقتصاديةً كاملة داخل السوق المحلي، كانت نتيجة هذا التحول انهيارًا تدريجيًا لبنية الطباعة الوطنية.
توقفت حركة الموردين المحليين للورق والأحبار بعد تراجع الطلب، فخسروا استثماراتهم، وتحول بعضهم إلى أنشطةٍ أخرى، هاجرت الكفاءات الفنية أو سُرّحت، وأُغلقت مطابع كبرى كانت تمثل حجر الزاوية في القطاع، وتفككت سلاسل القيمة المرتبطة بالنقل والصيانة والتوريد، ومع كل موسمٍ دراسي كانت الخسائر تتراكم، بينما تزداد تبعية الدولة للموردين الأجانب.
وحتى بعد عودة الدولة إلى سياستها في منح عقود الكتاب للمطابع المحلية، لم يتحقق الإصلاح المنشود، إذ تفاقمت الأزمة مع تبنّي سياساتٍ إدارية قصيرة الأجل وتعجيزية استُخدمت كذريعةٍ شكلية لإظهار الالتزام بالدعم المحلي، بينما أُفرغت السياسة من مضمونها العملي.
فقد مُنحت مهَلٌ لا تتجاوز خمسةً وأربعين يومًا لطباعة الكتاب وتوريده، وهي مهلةٌ غير واقعية بالنظر إلى متطلبات السوق وزمن توريد المواد الخام الذي لا يقل عن ستين يومًا في أفضل الأحوال.
وهكذا تحوّل “التمكين المحلي” إلى عبءٍ جديد على المطابع الوطنية بدل أن يكون فرصةً لدعمها، إذ طُرحت العقود بشروطٍ تجعل التنفيذ شبه مستحيل، لتُستخدم بعد ذلك كحجةٍ لإعادة التعاقد مع الشركات الأجنبية من جديد.
إلى جانب ذلك، يبرز غياب المعايير الواضحة في اختيار المطابع المحلية التي تُسند إليها عقود الطباعة، إذ يقتصر التقييم في الغالب على معيار “القدرة الإنتاجية”، من دون تحديدٍ دقيقٍ لمكوناته أو أدوات قياسه.
فمفهوم القدرة يختلف من مطبعةٍ إلى أخرى، ويُستخدم أحيانًا بطريقةٍ انتقائية تُبرّر الإقصاء أو التفضيل.
وهذه الإشكالية لا تؤثر فقط على اختيار المطابع الوطنية المنفذة، بل تمتد إلى توزيع الحصص فيما بينها، وهي الحلقة التي يتسلل منها الفساد في عملية الإسناد.
فالقدرة الحقيقية يجب أن تُقاس بمزيجٍ من ثلاثة عناصر مترابطة: المعدات الإنتاجية، والعمالة الفنية، وتوافر المواد الخام.
لكن في ظل السياسات الحالية التي عطّلت السوق وأضعفت الموردين، غابت المواد الخام وتراجعت العمالة الفنية، ما جعل “القدرة” نفسها شبه معدومة في الواقع.
المفارقة أن المطابع التي تُستبعد بحجة غياب القدرة هي في الغالب مطابع حقيقية وفاعلة، بينما تُسند العقود إلى شركاتٍ ورقية لا تملك معداتٍ ولا طاقةً إنتاجية، تُستخدم كواجهاتٍ شكلية لإعادة توزيع الطباعة من الباطن بكمياتٍ ضخمة.
وهكذا تتحول “القدرة” من معيارٍ فني إلى أداةٍ إدارية لإعادة إنتاج الفساد في كل دورة تعاقدٍ جديدة.
لقد أصبح التركيز على السعر بدلًا من القيمة، وعلى المدة بدلًا من الاستدامة، عنوانًا لسياساتٍ قصيرة النظر دمّرت أحد القطاعات القليلة القادرة على الاكتفاء الذاتي.
فكل عقدٍ وطني للطباعة يخلق فرص عمل، ويحرّك السوق، ويُبقي رأس المال داخل البلاد، بينما كل عقدٍ خارجي يُهرّب العملة الصعبة ويُضعف البنية الصناعية.
إنها معادلةٌ بسيطة، لكن صانع القرار تجاهلها لسنوات، فكانت النتيجة فقدان الثقة بين الدولة والمطابع الوطنية، وانهيار بيئة الاستثمار في مجالٍ كان يمكن أن يكون من أعمدة الاقتصاد المعرفي الليبي.
إن الحل لا يكمن في العودة إلى مركزية الدولة أو احتكارها لعملية الطباعة، بل في تحرير الكتاب المدرسي من البيروقراطية وفتح المجال للمنافسة المنظمة.
يمكن تحقيق ذلك عبر تحويل تمويل الكتاب إلى دعمٍ مباشرٍ للطالب، من خلال منحةٍ سنوية تُصرف عبر منظومة “أرباب الأسر” التي تمتلك قاعدة بياناتٍ شاملة لكل الأسر.
بهذه الخطوة، تتحول الدولة من منتجٍ مُحتكرٍ إلى منظّمٍ ذكي للسوق، تحتفظ بحقها في الملكية الفكرية والعلمية، وتراقب الأسعار والجودة دون أن تتورط في إدارة التفاصيل التشغيلية.
إنها آليةٌ تحقق توازنًا بين الكفاءة والعدالة، وتحفّز السوق الوطني على التطور الذاتي بدل انتظار أوامر الوزارات.
في المقابل، يجب ألا يُقاس نجاح العقود بمؤشر التكلفة فقط، بل بالعائد الاقتصادي الكلي على المدى الطويل، من حيث خلق فرص العمل، واستقرار سلاسل التوريد، وتدوير رأس المال داخل الاقتصاد المحلي.
كما ينبغي إبرام عقودٍ طويلة الأجل مع المطابع الوطنية لضمان الاستقرار، وتوفير تمويلٍ ميسّرٍ للمواد الخام، وإنشاء لجنةٍ وطنيةٍ دائمةٍ للكتاب المدرسي تضم خبراء من التعليم والاقتصاد والصناعة، إلى جانب نشر تقارير سنويةٍ شفافة حول تكاليف الإنتاج.
أما مجتمع الطباعة نفسه، فعليه مسؤولية لا تقلّ عن مسؤولية الدولة، فالإصلاح لا يتحقق بالتذمّر من السياسات الحكومية فحسب، بل بتأسيس منظومةٍ مهنيةٍ قادرةٍ على التنظيم الذاتي.
ينبغي أن تتوحّد المطابع الوطنية ضمن كيانٍ مهنيٍ مستقل يضع معايير واضحة للقدرة الفنية والإنتاجية، ويُحدّد بدقةٍ آليات تقييم الأداء وتوزيعالعقود، بما يضمن العدالة والتوازن بين مختلف الشركات.
كما يجب أن تتبنّى هذه المنظومة سياسات فنية شفافة تُحدّد عناصر القدرةبوضوح – من المعدات إلى العمالة إلى توافر المواد الخام – وأن تضع قواعدمهنية تُلزم جميع الأطراف باحترامها.
في الوقت نفسه، من الضروري تنقية القطاع من الشركات الوهمية والكيانات الورقية التي أضعفت سمعته وأفسدت المنافسة الشريفة.
فالمطابع الجادة مطالَبة بتقديم رؤية موحّدة تعيد الانضباط إلى السوق، وتحوّلها من ساحة تنازع إلى مجال إنتاج منظم يقوم على الشراكة والمسؤولية.
إن وجود كيان مهني قوي وشفاف لن يحمي فقط حقوق العاملين في القطاع، بل سيجعل صوتهم مسموعًا في صياغة السياسات المستقبلية، لتصبح صناعة الطباعة الوطنية جزءًا من منظومة التنمية، لا مجرد ضحية لقراراتها.
ما تتعرض له صناعة الطباعة في ليبيا ليس مجرد أزمة قطاعية، بل علامة على اختلال السياسات الاقتصادية والإدارية في الدولة.
فالكتاب المدرسي ليس سلعةً تستهلكها الوزارات كل عام، بل مقياس لجودة التعليم، ورمز لقدرة الدولة على إنتاج المعرفة بأدواتها الذاتية.
إن إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي كمنتج وطني ليست مجرد خطوة في قطاع التعليم، بل بداية فعلية لبناء اقتصاد معرفة يعيد للدولة هيبتها، وللمواطن مكانته في معادلة التنمية.